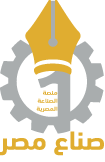تتحدث الكثير من كتب تطوير الذات (self development) عن الطرق التي يجب أن يتبعها الإنسان كي يبني نفسه ويطوّر من ذاته في نقاط كثيرة، عن طريق تنمية مهارات معينة كالمهارات الحسابية، والقدرة على تصفية الذهن، والتركيز العميق، والذاكرة، والاستيقاظ المبكر، والعادات المبنية بعناية… إلى آخره من الكلمات والشعارات الرنانة التي يتغنى بها أبناء جيل إكس وافتُتن بها أبناء جيل الألفية، وسعوا وراءها ظنًّا أنها مفتاح الباب الذي سيوصلهم إلى دنيا الأحلام.
ولا شك أن تطوير الذات هو صناعة رائجة جدًا، لكنها -في رأيي– تشبه كثيرًا ما نراه من مؤثري الإنستجرام والتيك توك، الـ food bloggers، أولئك الذين يذهبون إلى المطاعم كي يصفوا لك طعم الطعام الذي يتناولونه وما شعورهم تجاهه وتأثيره عليهم، ولكنها تظل تجربتهم هم وليست تجربتك أنت.
ويُوصف هذا السلوك بــ “العيش من خلال الآخرين” (living vicariously)، وهو ما رفضه جيل Z، فهم يواجهون كمًّا ضخمًا من التحديات، من تغيّر مناخي إلى صعود الذكاء الاصطناعي وتهديده لوظائفهم المحتملة، والأزمات الاقتصادية المتتالية، مما فرض عليهم أن يفكروا بواقعية أكبر بكثير من أي جيل مضى.
وتواجه مصر أكبر تحدٍّ بالمنطقة من حيث التنمية البشرية، إذ نملك طاقة كامنة هائلة من الشباب، حيث يمثل من هم دون سن الـ30 حوالي 60٪ من تعداد السكان. فماذا يمكن أن نصنع بكل هؤلاء؟ بينما متوسط العمر في ألمانيا وأوروبا لا يقل عن 45 عامًا!
يقول علماء الاجتماع إن البشر كائنات اجتماعية، وجزء رئيسي من الحياة الاجتماعية هو سرد القصص، حيث يتخيل علماء الاجتماع وعلماء الباليونتولوجي أن البشر الأوائل كانوا يتجمعون حول نار المعسكرات ويقصّون على بعضهم القصص، والتي لا تزال تُعد الوسيلة المفضلة لدى البشر لنقل الخبرات.
فماذا نفعل لبناء الجيل –بل الأجيال– القادمة من شباب مصر؟
خصوصًا بعد ما سبق وصفه من نماذج للتنمية الذاتية التي سادت خلال العقدين السابقين؟
الواقع أني –من خلال مسيرتي المهنية سواء على صعيد المؤسسات والشركات الخاصة أو على صعيد التعليم– وجدت أن أكثر الشباب اليوم يعانون من غياب المثل الأعلى، ويمكن أن نقول غياب المثل العليا عمومًا.
لقد كان جيلي –من مواليد النصف الثاني من السبعينات– سعيد الحظ لأنه من أبناء جيل أكتوبر، جيل الأبطال الذين واجهوا كل التحديات التي يمكن أن يواجهها بشر وتغلبوا عليها، فتعلمنا منهم الصمود والجلد. وكيف لا، وهم آباؤنا وأعمامنا وجيراننا، كانوا يعيشون بيننا، نراهم رأي العين، فاتخذناهم مصدرًا للإلهام.
وتلاهم أبطال مصريون في مجالات مختلفة مثل فاروق الباز، نجيب محفوظ، أحمد زويل، ومجدي يعقوب، سلط عليهم الضوء، وحظوا باهتمام الإعلام، ليقصوا علينا كيف وصلوا لما هم فيه من نجاح، وزادونا إلهامًا.
لكن مع بداية الألفية الثانية قلّ التركيز على هذه النماذج في الإعلام، وساهم تفتّت الإعلام إلى عشرات القنوات في تخفيف التركيز على النماذج الناجحة من المصريين، اللهم إلا محمد صلاح، والذي ساهم الإعلام العالمي أكثر من الإعلام المحلي في تسليط الضوء عليه.
ولذلك، وقبل أن نصف خطوات التنمية، لا بد أولًا من وجود الإلهام والمثل الذي يُحفّز الشباب ويصف لهم ما قام به الناجحون خلال مسيرتهم.
لا بد من بناء الجيل الجديد من الشباب –مستقبل مصر– من خلال سرد قصص نماذج ناجحة من أجيال سابقة وحالية من شباب مصر، لكي يكونوا النموذج الذي يُحتذى به من الأجيال القادمة، عن طريق تعريفهم وتوضيح:
أن النجاح ليس خطًا مستقيمًا، لكنه خط متعرج، يتميز بالصعود والهبوط دائمًا، ولكن المثابرة هي الوسيلة لعبوره. إن قصة نجاح كل شخص تختلف، وليس من الضروري أن تتطابق، ولكن الإكثار من النماذج يعطي وزنًا أكبر لما يُروى، ويوضح مدى اختلاف السبل.
أن القراءة هي طريق بناء القدرات، ليس قراءة كتب التنمية البشرية والربح السريع، بل كتب تعليم البرمجة، التسويق، الهندسة، التصميم، وغيرها من العلوم، وما يقابلها من التخصصات. الحصول على دبلومة رقمية هو خطوة جيدة، لكنها فقط المقدمة، ولا سبيل غير التعمق بعدها في التخصص المختار لبناء القدرات الحقيقية.
أن التطور المستمر هو سمة العالم اليوم، وما إن تنتهي من مرحلة حتى تلاحقك مرحلة أخرى، ولذلك يجب فهم أن التعلم عملية مستمرة لا تنتهي.
أن الفشل ليس عيبًا، بل هو نتيجة طبيعية للمحاولة. وكما قال أحد قادة صناعة التكنولوجيا عالميًا:
“اتخذ قرارات سريعة، إفشل أسرع، لتتعلم أسرع”.
إذا استطعنا بناء سلسلة من القصص، ولنقل على سبيل المثال بدلاً من “ألف ليلة وليلة”، تكون “ألف مشوار ومشوار”، نسطر فيها قصص نجاح من شباب مصر، وتُقدَّم للشباب في قالب يناسب استيعابهم المعاصر، نكون قد زرعنا بذرة في نفوسهم، تؤتي ثمارها حين تنفتح عقولهم على معنى “بناء الإنسان الحقيقي”، وتُفتح بذلك المجال للخطوات التالية، والتي هي ليست سهلة، لكنها ضرورية.
وللحديث بقية